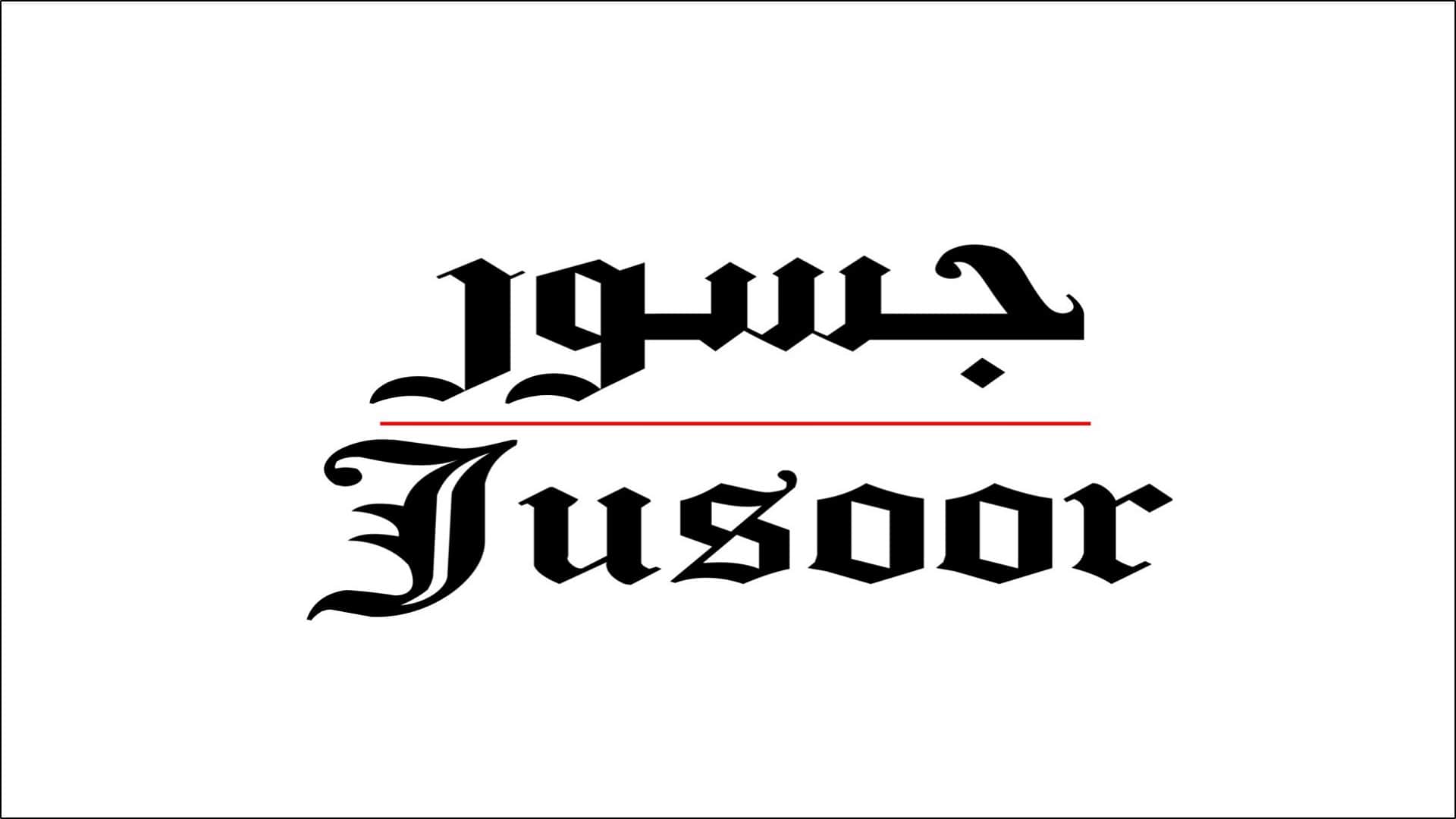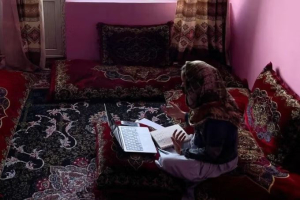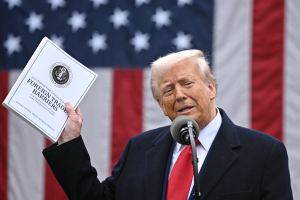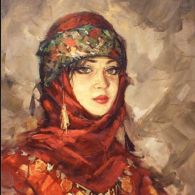من أور إلى بابل.. التراث العراقي ينهار تحت وطأة الجفاف والملوحة
من أور إلى بابل.. التراث العراقي ينهار تحت وطأة الجفاف والملوحة
في قلب واحدة من أقدم مناطق الحضارة الإنسانية، يواجه العراق اليوم تهديداً قد لا يقلّ خطورة عن الحروب التي اجتاحت البلد، فالجفاف المتواصل، والزحف الصحراوي، وتراجع نهري دجلة والفرات، وارتفاع ملوحة التربة والمياه، كلها عوامل تشكّل معاً خطر تآكل الذاكرة المادية للحضارات التي قامت على هذه الأرض وتعود لأكثر من أربعة آلاف سنة في ظل عجز عن إنقاذها، وتحت أنظار مجتمع يعيش تبعات أزمة بيئية وإنسانية شاملة.
وفق تقرير نشرته وكالة "رويترز"، يعد العراق من بين الدول الخمسة الأكثر تأثّراً بتغيّر المناخ، إذ يعاني من ارتفاع درجات الحرارة، وتراجع الأمطار، وزيادة الجفاف وحرارة الصيف إلى ما فوق الخمسين درجة مئوية في بعض المناطق، كذلك قد انخفض منسوب نهري دجلة والفرات بشكل ملاحظ، بفعل بناء السدود في تركيا وإيران وسوء إدارة الموارد المائية داخلياً، ما أدّى إلى خفض تدفق المياه وزيادة ملوحة التربة في الجنوب.
وفي موازاة ذلك، زادت وتيرة العواصف الرملية، وفق علماء آثار عراقيين، والذين يشيرون إلى أن الكثبان الرمليّة أصبحت تغطي أجزاءً واسعة من المواقع الأثرية وأنه ما بين 80 إلى 90 بالمئة من مواقع الجنوب قد تختفي تحت الرمال خلال العقد المقبل.
يتداخل مع ذلك الواقع البشري الجفاف والهجرة من الريف إلى المدن وانهيار الزراعة، وكلها عوامل تضع ضغطاً إضافياً على المجتمعات التي كانت تحرس تلك المواقع. وفي ظل غياب خطط وطنية واضحة لإنقاذ التراث الثقافي، تتوالى التحذيرات من وقوع كارثة وجودية للهوية التاريخية في العراق.
تداعيات إنسانية وثقافية
من حيث العمق الإنساني، ليست الأزمة مجرد تآكل مبانٍ طينية أو تلّ رُكام، بل هي فقدان مكوّن من مكونات الهوية الجماعية، ففي مدينة أور مهد النبي إبراهيم والحضارة السومرية، بدأ التآكل يظهر في الطبقة الثانية من الزقورة الشهيرة، وفق ما أكّده باحثون في دائرة الآثار بمحافظة ذي قار، كما أصبحت الرسوم والطوب الطيني التي توجد في بابل عرضة للانهيار بسبب الملوحة المرتفعة.
من جهة المجتمع، تؤثّر الأزمات المناخية في الأمن الغذائي، والزراعة، والتنمية الريفية، ما يدفع المزيد من السكان إلى الهجرة أو البطالة، وتشير منظمة الأمم المتحدة إلى أن العراق يعاني من ضعف التخطيط للتأقلم مع تغيّر المناخ، وتعد الهجرة البيئية والترحيل الداخلي من النتائج المباشرة.
في سياق التراث الثقافي، تحذر اليونسكو والمنظمات المعنية بالحفاظ على المواقع الأثرية من أن تأخر التدخّل يعني فقداناً لا يمكن تعويضه، فالمواقع الأثرية ليست مجرد حجارة، بل أرشيف إنساني للحضارة التي اخترعت الكتابة أولاً، والمدن الأولى، والزراعات الأولى، إزالتها أو دفنها تحت الرمال يعني خسارة تراثٍ عالمي.
ردود الأفعال المحلية والدولية
على المستوى المحلي، أطلق مسؤولون عراقيون عدة تنبيهات حادة بخصوص ضرورة تخصيص ميزانيات عاجلة لحماية التراث، وقال مدير عام دائرة الآثار في وزارة الثقافة العراقية إن المواقع الأثرية في بابل معرّضة للخطر في ظلّ تحدّيات صعبة جراء نقص التمويل. وفي محافظة ذي قار، قال باحثون إن الملوحة التي تظهر الآن في المياه الجوفية ستؤدي إلى انهيار كامل للطوب الطيني في مقبرة أور الملكية.
على المستوى الدولي، حذّرت اليونسكو والإدارة البيئية الدولية من أن العراق لا يستطيع وحده حماية تلك المواقع فالموقع التراثي للأهوار الجنوبية والعواصف الرملية المتزايدة يشكّلان تهديداً لمنظومة التراث العالمي، ما يستدعي تدخلاً دولياً، ومن منظور القانون الدولي، تجري حماية التراث الثقافي والبيئي عبر اتفاقيات مثل اتفاقية التراث العالمي واتفاقية رامسار للمناطق الرطبة، ما يجعل تأخّر التدخّل ليس مجرد خرقاً تقليدياً بل مساس بالتزامات دولية للحفاظ على المعالم ذات القيمة العالمية، فقد أشارت تقارير إلى أن الرطوبة، الملوحة، والرمال تهدّد مدينة الأهوار على نحوٍ يخالف التزامات العراق الدولية.
كما طرحت منظمات البيئة والحقوق توصيات عاجلة بتبني خطط وطنية للتكيف مع تغيّر المناخ تشمل حماية المياه، إعادة التشجير، وإدارة الرمال. وعُرض مشروع من اليونسكو لدعم العراق في تطوير أدوات لإدارة شُحّ المياه والموارد المائية ضمن محور التكيف المناخي.
خلفيات تاريخية وتجذر المشكلة
يُعد العراق منبع أولى الحضارات في التاريخ؛ فبلاد ما بين النهرين احتضنت مدينة أوركو وحضارة السومريين، وابتكرت الكتابة والزراعة والمدينة، غير أن هذا الإرث ضُرِب أولاً بالحروب (الحرب العراقية الإيرانية، حرب الخليج، الغزو الأمريكي، ثم تنظيم داعش)، ما أدّى إلى تخريب واسع للتراث والبنى التحتية، وحالياً، يُضاف إلى ذلك تغيّر المناخ.
منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، بدأت الأرض العراقية تفقد خُصوبتها، والمياه التي تشقّها منذ آلاف السنين تتناقص، والأرض التي كانت خصبة تتراجع للتحوّل إلى مناطق جافة. فالتشجير الضعيف، واستخدام المياه الجوفية المكثف، وتقلّص الأنهار كلها عوامل أضعفت قدرة التربة على مقاومة الريح والرمال.
محاور الإنقاذ الضرورية
تُشير الخبرات إلى أن الإنقاذ الممكن يجب أن يتناول ثلاث محاور: أولاً، صيانة عاجلة للمواقع الأثرية الأكثر هشاشة، بمساعدة تمويل دولي وخبرات متخصصة لإزالة الرمال، معالجة الملوحة، وتجفيف التربة حول الهياكل القائمة، ثانياً، معالجة أزمة المياه والتربة عبر تحسين إدارة الموارد، تقنيات الزراعة الذكية، ومشروعات التشجير والأحزمة الخضراء لمنع التصحّر، وثالثاً، تمكين المجتمع المحلي من حماية وفي ربط بين التراث والتنمية المحلية، بحيث تصبح حماية المواقع الأثرية جزءاً من الاقتصاد المحلي المستدام، لا مجرد عبء ثقافي يتحمّله الدولة وحدها.
كما تؤكّد المنظمات أن تأخير هذه الإجراءات يشكّل خسارة لا يمكن استدراكها، فكلّ عامٍ يمرّ دون معالجة يعني أن أجزاءً من التاريخ ستختفي إلى الأبد تحت الرمال أو تنهار بفعل الملوحة.
في هذا الإطار، تحتاج الحماية إلى التزام طويل الأمد، ليس فقط إنسانياً أو بيئياً، بل حضاري أيضاً؛ لأن العراق لا يحافظ فقط على تراثه، بل على ذاكرة البشرية كلها.